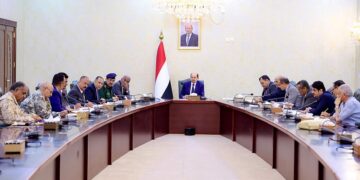محمد جميح:
بدأتُ الحياة العملية شاعراً متنقلاً بين القصائد العاطفية، والوطنية والقومية والروحانية، بين مجلس شاعر اليمن الراحل عبدالله البردوني، ومقيل شاعرها وناقدها عبدالعزيز المقالح، وكان الجمهور يصفق عندما أنتهي من قراءة كل قصيدة، وكانت القصيدة تكتمل اكتمالات أنثى في مقتبل العمر، أو زهرة تتفتح مع قدوم الربيع، ومع الزمن كبرت ثروتي من التصفيق، وامتلأت بزهو شاعر يطوي السماء بين جنبيه.
وذات مساء من عام 1994 ضمنا مجلس في صحيفة «الجماهير» البعثية في صنعاء، وكان الصديق الشاعر عبدالحفيظ النهاري حاضراً، وأنا ما أزال في سنة ثانية في جامعة صنعاء. سمع النهاري مني بعض القصائد، وقال لي مشجعاً: «أنت شاعر»، وانفجر نهر من السرور، وتفتحت زهرة الروح.
اتفقنا – بعدها – على أن نذهب إلى «مقيل» الدكتور عبدالعزيز المقالح، وكان حينها ينعقد كل أربعاء، في مركز الدراسات والبحوث في صنعاء. وذهبنا عصراً، وقرأت مجموعة من القصائد في مقيل المقالح، وقال لي: «أنت شاعر».
ظللت أستذكر الكلمتين اللتين قالهما المقالح، وأضمهما إلى كلمتين قالهما عبدالحفيظ النهاري، ليصبح رأسمالي أربع كلمات، ولأشعر بشيء من البهجة لا يشعر به من يمتلك كنوز المال. أجاز المقالح – إذن – دخول بعيري إلى سوق عكاظ، وجاورت نابغة بني ذبيان، وانطلقت أحدث كل من لقيت، أن المقالح شهد لي بالشاعرية. لزمت – بعد ذلك متصوفاً – مقيل المقالح قرابة عشر سنوات إلى أن جئت إلى المملكة المتحدة لإكمال الدكتوراه، التي انتهيت منها قبل سنوات.
خلال الفترة السابقة شاركت في عدد من الفعاليات الثقافية والشعرية والمهرجانات داخل اليمن وخارجه، وكان الجمهور يصفق لي على كل قصيدة أقولها، وأنا أنتقل من معنى إلى معنى، ومن زهرة إلى أخرى. ثم جاءت السياسة. صدفة جاءت، من دون أن أخطط لها أو أتمناها، فانقسم جمهوري الذي كان يصفق كله لسماع القصيدة إلى قسمين: قسم يؤيد وآخر يخوّن، وكانت تلك أولى الخسائر.
تذكرت صديقي القديم الشاعر عبدالحفيظ النهاري، الذي أصبح على الضفة السياسية المقابلة، رغم امتداد شيء من الود والشعر لا يزال يربط الضفتين. يخيل لي أن الذي اخترع الجسر هو ذاته الذي أبدع الشعر، ولذا أحضر أحياناً إلى «جسر واترلو» في لندن لأتواصل مع الضفاف البعيدة. وقبل شهور لقيت في لندن الشاعر العراقي علي جعفر العلاق، وهو أستاذي في مادة الأدب العربي الحديث، في جامعة صنعاء، وكان مرة قد قال لي، وأنا في بيته في صنعاء: «أرى فيك شبابي»، وليلتها انطلقت أجمع كلماته إلى الكلمات التي قالها لي المقالح والنهاري، وأضاعف ثروتي التي لا تقدر بثمن. لقيت العلاق في لندن، وفي عينيه عتب على هجراني القصيدة إلى هذا الحد، الذي لم يعد ممكناً معه مد جسور التواصل معها، كما كنا أيام كان العلاق يجلس إلى جوار المقالح، ونحن نقول الشعر، ليبدأ بعد الشعر حديث النقد والفن والحياة.
كان في المقيل القاص والناقد العراقي شاكر خصباك، والشاعر العربي الكبير سليمان العيسى الذي مات مقهوراً في دمشق، وكان يأتي أدونيس وجابر عصفور وكمال أبوديب وعزالدين إسماعيل، ومحسن أطيمش، ومحمد حسين هيثم، وأحمد العواضي، وعبدالسلام الكبسي، وأحمد الزراعي، ومحيي الدين جرمه، وجلس فيه «النوبلي» فونتر غراس، وكان مكان خالد الرويشان في صدر المجلس بكلامه الهادئ المرتب القليل. خالد الرويشان كلامه وفكره كشخصيته، كله مرتب وأنيق ومنسجم مع نفسه والآخرين.
وجاءت السياسة وفرقت بيني وبين كثير من أصدقائي الشعراء والروائيين، ومرة أرسل لي زميل دراسة يقول: «خنت وطنك وأهلك»، لأنه اصطف سياسياً مع معسكر وأنا مع آخر، وفي المقابل قالي لي صديق مشترك بيني وبين الصديق الذي خونني: والله إنك تكبر في عيني يوماً بعد يوم. وهكذا يختلف الناس الذين «لم يجمعوا حتى على رب العالمين» على حد تعبير أحد المؤمنين بالديمقراطية وحرية الاختلاف.
وذات مساء رأيت – في الشاشة – إلى جوار رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي رجلاً ما كنت أظن أنه يمكن أن يكون هناك، كان أستاذي في النحو والصرف الدكتور طارق نجم عبدالله، الذي مكث في صنعاء تسع سنوات، وقد ربطتنا به علاقة احترام كبير، وكنا نحضر له أثناء الإعداد لدرجة الماجستير، وبعد دخول الأمريكيين بغداد، ومجيء نوري المالكي أصبح الدكتور طارق مدير مكتب المالكي وساعده الأيمن، حيث لم نكن في اليمن طول فترة السنوات التسع نعلم أنه قيادي كبير في حزب الدعوة الشيعي (وما كان ذلك يعنينا) الذي يحكم العراق اليوم، لتخسر الأكاديميا أحد رجالها لصالح السياسة مرة أخرى.
وتمر السنوات والأحداث والمواقف في شريط سريع أمامي منذ اليوم الأول الذي قدمت فيه من مأرب إلى صنعاء، غير أني ما زال داخلي ذلك البدوي الذي قدم من مأرب يتلمس شخصيته في عيون القصائد والنساء، ويكتب في السياسة برؤية أهل البادية، الذين يرون في الأفق البعيد مخايل الغيوم المقبلة، ويميل إلى حدسه الذي لا يكذب عندما يخبره عن الناس والأشياء والمواقف والحياة.
وقبل أسابيع عدت إلى اليمن بعد مشاركتي في مهرجان الجنادرية في السعودية، وركبت السيارة من الرياض إلى مأرب على الطريق الصحراوي الممتد من ضفة الرمل إلى ضفة الرمل. كانت الصحراء أمي الأولى، وكانت الكثبان العالية تبتعد وتقترب، والجمال السائمة تسرح بين الكثبان، وكنت في الصحراء في حالة من «الجذب الصوفي»، أو العطش اللاشعوري، لا إلى الماء، ولكن إلى الرمل، إلى الشعر، إلى «مضارب البدو»، التي كانت تلوح بين الحين والآخر، وتنسرب منها حكايات العرب الأوائل، وأحاديث الخيام في ليالي الصحراء المقمرة، وما حفظته لنا الأشعار من مغامرات الصعاليك، وأشواق الرعاة، وهمس عاشقين التقيا مساء على ضفة الرمل، يتجاذبان أطراف الحديث، ويناجيان النجوم. لا تزال الصحراء العربية تحتفظ بقصص لا تحصى محفورة على سفر رمالها لقبائل العرب وأيامهم، وتاريخ من الانكسار والانتصار والمقاومة لعوامل الفناء في هذه «المفازة» التي لا تنتهي. وفي مأرب، كما في الرياض يلقاك العربي بكرمه وضيافته، وتحضر الحكمة والشعر، وتحضر غالباً السياسة التي أصبحنا نأكلها مع وجبات الطعام، وتعطي قهوتنا العربية مرارتها المعهودة.
هل جرب أحدكم النوم ـ ليلاً – على سطح منزل صحراوي مفتوح على السماء؟ حيث النجوم غير النجوم، والسماء غير السماء، والسكون الروحي انعكاس لصمت الرمال المزمن وحكمتها الأبدية، في مساءات البادية تبدو النجوم كفتحات سحرية في القماشة التي صُنعتْ منها خيمة السماء الداكنه، نوافذ تفضي إلى العالم الأعلى، وتشي في ظلمة الليالي ببعض الغيب فوق القبة السماوية المدهشة.
وتستمر الحكايات، وقبل أيام اتصلت من لندن بصديق في صنعاء؟ قلت له: كيف أنت؟ قال: بخير. قلت كيف صنعاء؟ قال: بخير، وأنهينا المكالمة وأنا أتأمل في طبيعة شعب رائع يقول إنه بخير، وأن بلاده بخير، ويمارس حياته ويبتسم ويقول «النكتة»، في زمن الحرب.
غداً تذهب الحرب، ويعود الإخوة يأكلون من صحن واحد، وغداً تعود القصيدة التي غادرت عشية اندلاع الصراع.
إذا اشتبكتْ يوماً فسالتْ دماؤها
تذكّرت القُربى فسالتْ دموعها