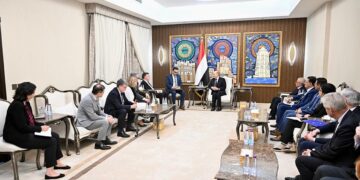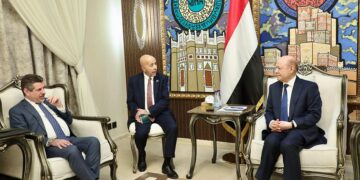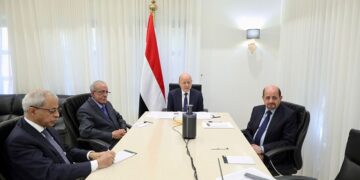المرثية الأخيرة أشهد أني عشت حياتي، قطفت من كل مرحلة، أشهى ما يمكنني الحصول عليه، تتابعت الفصول وتدرجت، وأخذت دوراتها الطبيعية، وأنا أدور معها، في الصيف آن الكرم يقتطف، كنت أعيش مع قاطفات العنب في جبال اليونان، وسهول تركيا، فتهب رياح الخريف، وتنثر في الأجواء الأوراق الصفراء، اليابسة، وتعري الشجر من ملبوساته.
فاختبأت داخل شرنقة الحياة، حتى تكتمل دورتي، في الشتاء ذهبت بحثا عن البياض، في بلاد الثلوج كي أغتسل برذاذه الناعم، وأعيش متعة الأرتواء، ثم يأتي الربيع، لتزهر البراعم، وتتفتح الأقحوانات، وتلمع الكواكب في السماوات الزرقاء الصافية، فأركض باتجاه صديقي البحر، ليطهرني من أدران التعب اليومي، ويغسل همومي وأحزاني، بأمواجه البيضاء البلّورية، هذا ترف عشته، دون تخطيط أو رسومات.
هكذا رُسمت أقداري، لم أتدخل في توجيه تضاريسها .. تلك طريقة وجدتها أمامي، فمشيت .. دون فلسفة أو أي تفسسر عقلاني أو ميتافيزيقي؟، لست أنا من يقرر قدري ومصيري! ذلك شأن البشرية منذ البدايات الأولى للطفولة البشرية، وقبل تشكل الحضارات ! لذا فإن الموت والحياة بيد الله، وما بينهما من برزخ دنيوي وآخروي، هو ما كتب أن نعيشها، بالقليل من الرضى والكثير من التذمرات والشكاوى .. خلق الإنسان هلوعا.
لا أدعي أني عشت طفولة ذهبية ، وفي نفس الوقت لم أعش طفولة محرومة أو بائسة ، وما بينهما تتالت مراحل العمر ( الصبا – الشباب – الرجولة – خريف العمر – الكهولة – الشيخوخة ، ولم أصل بعد لأرذل العمر ! سافرت كثيرا ، شاهدت عالما أجمل، عشت السعادة والمرارة ، مررت بخيبات ومحطات مشرقة قرأت كثيرا ، وكان الكتاب صديقي الذي لا يفارقني : وخير جليس في الزمان كتاب . ولكنها في الأخير ، كلها محصلة حياتي . ومن يعش حولا – لا أبا لك – يسأم . كان أبي – رحمه الله – يخاف من الموت ، ظل هاجسه الذي لا يفارقه بقية عمره . كان يقول أن الفواق ( الفهقة ) من علامات النزع الأخير ! ( الزغطّة ) كما يطلق عليها أهل مصر . وكان أبي يثير زوبعته كلما جاءت الفهقة – العلامة ، كي تأخذه للشهيق الأخير . كنت في تعز أشاهد مع حفيدي الجميل – الصغير الحسين ، مسلسلات توم وجيري ، وكثيرا ما تتكرر تلك المطارادات التي لا تنتهي.
كان الكلب الشرس الضخم يحاول أن يجعل طفله الصغير المدلل أن ينام ، بعد أن أنهكته الفهقة ، وفي لحظات السكون ، تأتي عاصفة الضجيج القادمة من المطاردات العبثية ، التي تزيد الموقف سخرية وإضحاكا ! كم هي المرات التي شاهدت فيها هذا المنظر ، ولكن الكلب لا يموت من الفواق – الفهقة – الزغطّة حين أتلقى العزاء ، أرجو ألّا أصنف ضمن الرجل الذى قضى معظم حياته مناضلا في سبيل الوطن.
لا أحبذ الكلمة، مستهلكة، انتزعت من مسارها التاريخي، ولن تضيف شيئا لسيرتي لا أعتقد أن أحدكم سيحتج على ذلك، لأن حب الوطن، لا يحتاج إلى شهادة من أحد.
رحل الذين أحبهم، وسيرحل البقية ، لا ديمومة لحيّ . لذا فإن الموت لا يخيف، يأتي أحيانًا خلاصا من عذابات الحياة الأخيرة، والفنان المجاهد وغيره رحلوا وهم يبتسمون للنجوم.
ستقيمون لي العزاء، ويكتسي الحزن وجوهكم ، وتتناقلون الخبر الأسيف ، واستعادة الذكرى المشتركة ، والحكايات التي عشناها معا … ثم تمضي الأيام، وتمر السنين، ولا تتوقف دورات الفصول عن الحركة.
أصعب مرحلة في هذا الرحيل والرثاء، كيفية تفسير غياب الراحل للأحفاد، حين يفتقدون عجوزهم الذي كان هنا يوما ما، يداعبهم ، يلاعبهم، وفجأة اختفى! حزن الأحبة هو الذي يترك الغصة، الزوجة والأولاد، ولكن هذه سنّة الحياة.
الوداع .. الوداع، لكل من حمل سنبلة أو وردة، ليعطر ذكراي، وينشر فوح البخور العدني، كلما سنحت له نسائم الذكرى.