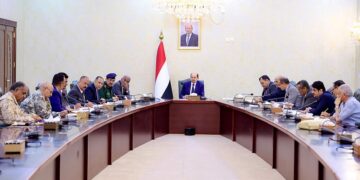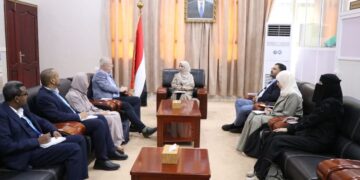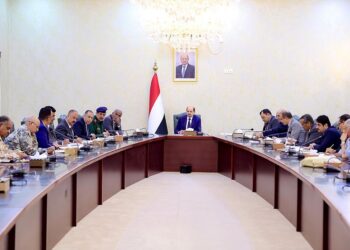على أسوار قصر الحمراء ومدينة غرناطة، لم أجد غادة أندلسية تنتظرنى كما وجد نزار قبانى فى قصيدته الشهيرة التى قال فيها: (فى مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطـيب اللقـيا بلا ميعاد) .
بل وجدتُ مثل كل مرة أزور فيها الأندلس وأنا أحبها حتما، وجدتُ ذاك الثقل الوجدانى لتاريخ آخر أيام العرب فيها، وكيف ياالله يشبه حاضرنا العربى اليوم، مما يجعلها لحظات مثقلة بالوجد والحزن معا.
وبطبيعة الحال لم أجد فى الطائرة غادة أخرى كما وجدها الشاعر عمر أبو ريشة فى قصيدته الأسبق أيضا عن الأندلس، وهو يقول للجميلة بجانبه فى مقعد الطائرة برحلة له:
(قلت يا حسناء مَن أنت? ومن أى دوح أفرع الغصن وطالا.. فرنت شامخة أحسبها.. فوق أنساب البرايا تتعالى… وأجابت أنا من أندلس.. جنة الدنيا سهولا وجبالا).
لم أجد ذلك فأنا دخلت الأندلس على متن سفينة أولا فى البحر لا طائرة، ومشيت فى سهولها بسيارتى ثانية، أتفقد قصة أخرى لا تزال تسكن خاطرى مع كل إطلالة أقوم بها لهذه الأرض الجميلة.
أعنى بذلك قصة ملوك الطوائف العربية فى آخر أيامهم، (وما أشبه الليلة بالبارحة) مع تغير الأرض حيث غدا الوطن العربى كله اندلسا أخرى فى آخر أيامها، تتنازعه سيوف الطوائف!.
لا أحتاج إلى حديث مطول عن المشترك الثقافي، وعلاقتنا بتاريخ هذه الأرض، من نغمة أغانى الأندلس الحزينة التى قُدّت من مواويل جبال قريتنا، وكأنى أسمع رجع صدى للحن يمانى إلى كل أثر وخط تراه هناك.
ومن يعود إلى تاريخ المعافر فى تعز قلب اليمن، سيجد امتداد بريقه على هذه الجبال، وكنت قد سعدت بالمشاركة فى الإشراف على اصدار سلسلة كتب عن تعز عاصمة الثقافة اليمنية، منذ قُرابة عشر سنوات، وبدأناها بكتاب مهم عن المعافرين بالأندلس، أما صدمة البصر فى كل زيارة أقوم بها للاندلس فهى تزيد الأمر شجنا أكثر، ولا يرتد خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ).
وفى مدينة مالقة التى تتباهى بأنها مسقط بيكاسو، تضج من حوليك موسيقى الفرح وتجد خلف كل حجر ونغم قصة جرح لا يندمل، حيث كانت مجازر الاستيلاء على المدينة أكثر قصص التاريخ وحشية، فقد دافع السكان عن مدينتهم حتى صارت الجثث تغطى شوارعها، ولم يدخل غزو الشمال لها بعد تدميرها لأيام بسبب صعوبة تقبل رائحة الجثث التى تعفنت.
وبعد قرون صارت القوى السياسية تخجل من إحياء تلك المجازر وأنها انتصارات. حيث يعتبر سقوط مالقة أحد أكثر الأحداث قسوة فى تاريخ سقوط الأندلس، ولم يكن هذا الوصف من قبل أحد المؤرخين المسلمين أو المهتمين بالشأن الموريسكى فقط، بل كان هذا التوصيف هو توصيف أحد أكبر الأحزاب السياسية الإسبانية وهو حزب الشعب كما قرأت، والذى أظهر رفضه الشديد لإحياء ذكرى هذه الأحداث الوحشية، كما وصفها بيان الحزب.
وإذا كانت الأندلس، تتجاوز أزمة التأريخ، وهى تحيى آثار الأمس، من أجل المستقبل الذى يتجاوز جروحاً غائرة، ستبقى ماثلة فى رقصة الفلاح المنكوب التى صارت اسمها (فلامنكو).
وكما قال المفكر الألمانى والتر بنيامين وهو يتحدث عن تمثال فى برلين وهو عبارة عن ملاك ينظر إلى الخلف، (أن النظر إلى الخلف أمر جوهرى من أجل المستقبل، ومن أجل الحياة ومن أجل الذاكرة).
لكن بالنسبة لى الأمر يختلف، أسير فى جبال نسخت من ملامح أجدادنا (اليمانيين) الذين تاهوا عشقا ذات يوم فى هذه الأرض، وأنا مشدود لواقع عربى معيش مؤلم، لم يستنسخ من ذاك التاريخ العريق والأرض المشرقة، إلا شتات طوائفه واحتراب قادته، وأغانى الشجن.
حيث تركنا كل ماله علاقة بالحضارة والإنجاز، وأبقينا على وصمة صراع ملوك الطوائف العربية فى آخر أيامهم بالأندلس تجتاحنا اليوم .
ولا أدرى ما إذا كان ما يجرى لنا الآن عربيا من احتراب هو آخر أيامنا، أم يمهد القدر ليقظة أخرى ستأتى بأندلس جديدة. ؟!
أسأل وفى خاطرى قصيدة أحمد عبد المعطى حجازى إلى جاك بيرك :
(فلنقلْ، نحن هنا أندلسيّونَ! فلا نطلب فى الأرض سوى ما يطلب الحُجَّاجُ، أبناءُ السبيلْ).
الكاتب سفير اليمن في المغرب
نقلا عن جريده الاهرام المصريه