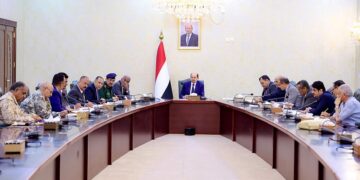كان من السهل، حتى ثورة 2011، التعامل مع الحوثيين على أساس أن قضيتهم قضية هامشية. ولئن كان من المؤكد أن المتعاطفين مع الحوثيين كانوا موجودين في صنعاء، وأن القتال يقترب بين الفينة والأخرى من العاصمة اليمنية، فإن الحركة كانت -إلى حدّ بعيد- تعد حركة سرية خارج نطاق معقلها الرئيس. وقد تغيّر هذا الأمر جذريا في سياق مجريات الثورة التي اندلعت عام 2011 ضد علي عبدالله صالح.
يشير آدم براون في بحثه الذي حمل عنوان “حروب صالح والحوثيين في اليمن”، إلى أنّ الحركة الحوثية قد لحقت مبكرا بركب الثورة ضد صالح، وأعلنت تأييدها مسبقا للعديد من الشخصيات والفصائل، وقد أفضت الثورة بالنسبة للحوثيين إلى توفير وسيلتين رئيسيتين لتحقيق المكاسب.
الوسيلة الأولى تتمثل في أنه مع تراخي قبضة الحكومة المركزية في الكثير من أنحاء البلاد، تمكن الحوثيون من إحكام سيطرتهم على العديد من المناطق، وبصفة خاصة في أغلب أجزاء محافظة صعدة، حيث نصبوا أنفسهم حكومة بحكم الأمر الواقع في أجزاء من البلاد منذ شهر مارس 2011. وأما الوسيلة الثانية، فهي تتمثل في أن الانتفاضة أدت إلى انفتاح في الفضاء السياسي باليمن، مما سمح للحوثيين بأن يعملوا في العلن أمام الملأ وعلى رؤوس الأشهاد، في العديد من أرجاء البلاد؛ حيث ظلت شعارات الحوثيين وملصقاتهم معلقة في مواقع واضحة للعيان داخل ساحة التغيير في صنعاء، مع وجود السلاح الحوثي في المعسكرات، حيث سجلت حضورا لافتا في ساحة التغيير.
ويشير براون في بحثه الذي تضمنه كتاب “اليمن مِن الإمامة إلى عاصفة الحزم” الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي، إلى أنه ومع التركيز على عمليات الوساطة المدعومة من دول الخليج لحل الأزمة السياسية بين حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح) وفصائل المعارضة، كان التهميش النسبي من نصيب الحوثيين، فضلا عن مطالب الانفصاليين في جنوب اليمن، الذي كان في الماضي دولة مستقلة. وفي حين أن صفقة سياسية أبرمت بالفعل في نهاية المطاف بمدينة الرياض في نوفمبر 2011، ومهدت الطريق أمام إدماج الحوثيين في عملية انتقالية، فقد صيغت مسودة تلك الاتفاقية دون مشاركتهم.
أدى ذلك التهميش إلى أن يحتل الحوثيون موقعهم على مقاعد المعارضة ضد الحكومة الانتقالية في اليمن، حتى وإن اضطلعوا بأدوار بارزة في الأجهزة الانتقالية الرئيسة، مثل مؤتمر الحوار الوطني اليمني، ويأتي ذلك -في الغالب- بالاقتران مع انتقادات لاذعة موجهة سهامها على المستوى الشخصي إلى سفير الولايات المتحدة وقتها، جيرالد فيرستن، الذي لعب دورا واضحا في الفترة الانتقالية، حيث يعود ذلك -جزئيا- إلى الصلات الوثيقة للولايات المتحدة مع حكومة الرئيس عبدربه منصور، حول الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وفي حين أن الاتصالات عبر القنوات والأبواب الخلفية قد تزايدت مع الحوثيين، فقد واصل الحوثيون رفضهم للاجتماعات العلنية مع المسؤولين الأميركيين، ووصل بهم الأمر إلى درجة مقاطعة الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني، بسبب حضور السفير الأميركي.
ربما كان الالتزام الأيديولوجي تجاه “النجاح” في اليمن، هو الذي أفضى إلى غبش الرؤية وتشوش الآراء، الأمر الذي جعل حتى وكالات الاستخبارات الأميركية تصنف استيلاء الحوثيين على صنعاء بأنه مفاجئ. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، كان ذلك يمثل تحولا مفصليا مثيراً؛ ذلك لأنه في غضون أيام تحولت العاصمة اليمنية من عاصمة لحكومة موالية للأميركيين، إلى مدينة سيطر عليها متمردون مناهضون للأميركيين، وعلى خلاف عميق معهم.
وقد أثبتت الجهود المبذولة لتحقيق السلام أنها مجرد حل مؤقت، لا سيما وأن الاتفاقيات ظلت تنهار الواحدة تلو الأخرى، في غمرة جهود الحوثيين الحثيثة لترسيخ قوتهم، جاعلين بذلك من الحضور المحض للأميركيين في البلاد أمراً غير ذي جدوى، كما يتراءى للمراقب يوماً بعد يوم.
وبحلول منتصف شهر مارس أخلى موظفو السفارة الأميركية مواقعهم في السفارة وغادروا البلاد، في حين أن الجنود الأميركيين المتمركزين في صنعاء وقاعدة العند الجوية عاودوا الانتشار. وبنهاية الشهر انطلقت عاصفة الحزم، فأتت بالأميركيين وجها لوجه مع الحوثيين.
في واقع الأمر، تحسنت العلاقات بالفعل بين الولايات المتحدة والحوثيين في الآونة الأخيرة، وإن ظلت في حالة من الاسترخاء، في حين أن استمرار الحكومة الأميركية في انتقاد الحركة الحوثية لاستيلائها على العاصمة اليمنية، ودعم الأميركيين القوي لعاصفة الحزم، قد يشير إلى خلاف ذلك.
وفي نهاية المطاف قبل بداية التدخل العسكري السعودي في اليمن لإعادة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى سدة الحكم كان ما يلي بصدد الحدوث: إن الدمج المتزايد للحوثيين في العملية الانتقالية -الذي يتضح من مشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني- أدى إلى أن يفتح اللاعبون الغربيون الآخرون قنوات التواصل مع الحوثيين. وحتى إن استمرت الجماعة الحوثية في مقاطعتها للاجتماعات المباشرة مع المسؤولين الأميركيين، مع المحافظة على تيار ثابت من الخطاب المناوئ للأميركيين، فإن نوعا من ذوبان الجليد وتليين المواقف قد حدث، ودليله الزيارة التي قام بها المسؤول الحوثي القيادي: علي العماد إلى واشنطن (منطقة كولومبيا) لاجتماع خاص بالبنك الدولي في نوفمبر 2014، وهي أول زيارة يقوم بها قيادي حوثي إلى الولايات المتحدة منذ ظهور المجموعة الحوثية على مسرح الأحداث.
منذ انطلاق عاصفة الحزم أدت الوساطة العمانية إلى تسهيل التواصل بين الحوثيين والمسؤولين الأميركيين على مستويات متعددة، وخاصة في ما يتعلق بالإفراج عن المواطنين الأميركيين الذين تحتجزهم المجموعة في اليمن. ومن الملاحظ -بكل حال- أن الجولات الحديثة من المفاوضات شهدت مشاركة الحوثيين في الحوارات متعددة الأطراف، بحضور المسؤولين الأميركيين. ويمثل هذا تحولا بعد سنين من مقاطعة مثل هذه الاجتماعات.
ويخلص آدم براون، في بحثه إلى أن مصير العلاقات الأميركية- الحوثية سيظل ضبابيا وغير واضح.
الحكومة الأميركية كانت بطيئة في التعرف على انتفاضة المجموعة، وعلى العوامل الكامنة من ورائها، وعلى قوتهم المتنامية يوما بعد يوم. وفي العديد من الأوجه، يعد ما تقدم من أعراض سياسات الولايات المتحدة في اليمن بصفة عامة: ففي سياق التركيز الطاغي على الأمور السياسية في صنعاء، كانت الحكومة الأميركية بطيئة في الوقوف على صورة كاملة عن التصدعات في حكومة صالح، وأوجه القصور التي كانت تعتري تلك الحكومة، وعن التوترات التي شهدتها الفترة الانتقالية، سواء تلك التي كان سببها صعود الحوثيين، أو ما يتعلق بالشعور العميق بالتهميش في الجنوب. وبما أن الائتلاف الذي تقوده السعودية هو الموجود حاليا على دفة القيادة، فإن السياسات الأميركية في اليمن -وتحديدا في ما يتعلق بالحركة الحوثية- من المحتمل أن تستمر في أن تستمد مفاتيحها من حلفاء أميركا الخليجيين.
نقلا عن العرب اللندنيه